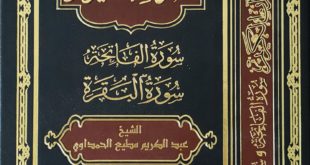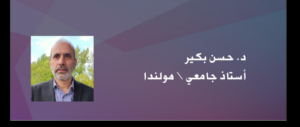
التمهيد لعلم المقاصد
يُعدُّ عصر التشريع الأول أقرب العصور إلى روح الشريعة وأسرارها وحِكَمِهَا؛ فالصحابة الكرام – رضي الله عنهم – ومَنْ بعدهم مِنْ فقهاء التابعين توفر – لديهم – من فضل الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن دقيق الفهم للغة القرآن الكريم وظروف التنـزيل ما جعلهم أقدر على فهم مقاصد التشريع، والاجتهاد وفق ما تقتضيه هذه المقاصد.
وقد عرفت مسيرة فقه المقاصد خطواتها الأولى بعد زمن التشريع الأول [عهد الرسول صلى الله عليه وسلم] عن طريق الاجتهاد بالرأي والقياس؛ حيث تمثلت الخطوات الأساسية لبروز المقاصد فيما عُرف بالاستحسان لدى الأحناف وغيرهم، ثم تطورت هذه الخطوات لدى المالكية فيما عُرف لديهم بالمصالح المرسلة والمناسب المرسل، والاستدلال المرسل…
ومع تطور حركة الاجتهاد الفقهي، واتساع دائرة المباحث الأصولية – لا سيما مباحث القياس – بدأت الإشارة إلى قضايا المقاصد في ثنايا كتب الأصول.
ولعل إمام الحرمين من أبرز من أشار إليها في مصنفه القيم «البرهان»؛ إذ نجد القسم المخصص للقياس مليئاً بتلك الإشارات، كقوله – مثلاً -: « والذي تحقق لنا من مسلكهم [ الصحابة الكرام ] النظر إلى المصالح والمراشد والاستحثاث على اعتبار محاسن الشريعة »([1])، وقوله: « ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع الشريعة »([2]).
وقد جاء تلميذه الغزالي ليقيم ركائز مهمةً في سياق بناء أسس فقه المقاصد؛ فتحدث عن أصول المقاصد، وقسمها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية([3]). كما حدد الكليات الضرورية التي هي الدين والنفس والعقل والنسب والمال، مستدلاً عليها، وممثلاً لكل واحدة منها، ومن خلالها حاول ضبط مفهوم المصلحة في الشريعة.
لقد دفع الغزالي بفقه المقاصد خطوات مهمةً تدل على استيعاب جيد لما سبقه من إشارات في هذا الاتجاه. ولعل في كتابيه: «شفاء الغليل» و«المستصفى» – على وجه الخصوص – ما يكشف عن مدى إسهامه في الدفع بالمقاصد إلى مراحل أكثر نضجاً وإِنْ لم تبلغ مستوى التأصيل العلمي الذي شهدته على يد الشاطبي.
وأبرز الأصوليين – بعد الغزالي – تناولوا المباحث ذات العلاقة بالمقاصد في سياق الحديث عن تعليل الأحكام ودراسة الأقيسة.
ومن هؤلاء: فخر الدين الرازي كما يلاحظ في كتابه «المحصول»([4])، والآمدي فإنه قد استخدم في «الإحكام»([5]) أصول المقاصد في باب الترجيح بين الأقيسة. فسار على نهجه كثير من الأصوليين.
ويأتي العز بن عبد السلام ليشكل – بكتابه الشهير: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» – حلقةً تُعتبَرُ أساساً في سلسلة الفقه المقاصدي؛ لأنه قد خصص المقاصد بالحديث، ولخصها في أساس مهم. هو جلب المصالح ودرء المفاسد. يقول – في كتابه المذكور([6]) -: « ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها ». ثم يؤكد هذا المعنى بقوله: « والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح »([7]). وقد ذكر العديد من الأمثلة لتعليل الأحكام الجزئية وبيان ارتباطها بمقاصدها.
ومما لا يمكن إغفاله اهتمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم بهذا الموضوع [المقاصد]؛ فموسوعاتهما الفقهية حملت كثيراً من الإشارات إلى حِكَمِ الشريعة ومقاصدها. يقول ابن تيمية – في هذا الصدد – :« إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما…» ([8]).
أما ابن القيم فكتابه القيم «إعلام الموقعين» غني بالحديث عن مقاصد الشريعة وحكمها. ومما جاء فيه([9]) – على سبيل المثال – قوله: « الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَمِ ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها ».
هذا. وقد قدم الإمام المقري إسهاماً واضحاً في سبيل تطوير المقاصد مادةً ومنهجاً([10])؛ فكانت جهوده وجهود من سبقه – من الفقهاء والأصوليين – ممهدةً لظهور الإمام الشاطبي الذي يشكل الحلقة الأساس في فقه المقاصد.
الشاطبي والمقاصد:
يُعدُّ كتاب «الموافقات» أهم مؤلف للشاطبي تضمن عرض النظرية وتوضيحها. لكنه ليس المؤلف الوحيد، ففي كتبه الأخرى – لاسيما «الاعتصام»، وكتاب «الإفادات والإنشادات»، و«الفتاوى»([11]) – ملامح كثيرة للنظرية، مما يدل على تبلورها لديه ووضوحها تمام الوضوح.
وضع الشاطبي كتابه: «الموافقات» في خمسة أقسام وخاتمة، تضمن القسم الأول منها المقدمات – وهي ثلاث عشرة مقدمة – مشتملة على المبادئ العامة الضرورية لفهم مباحث الكتاب.
أما القسم الثاني، فقد تطرق فيه إلى الأحكام الخمسة التكليفية والأحكام الخمسة الوضعية مبيِّناً ارتباطها بمقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد.
وخصص القسم الثالث للمقاصد الشرعية وما يتعلق بها من أحكام. ويُعدُّ – هذا القسم – الأبرز في التأصيل لفقه المقاصد.
أما القسم الرابع، فكان للحديث عن الأدلة الشرعية، ومآخذها وطرق الحكم بها على أفعال المكلفين.
وفي الخاتمة [القسم الخامس]، تحدث عن أحكام الاجتهاد والتقليد ولواحقهما من التعارض والترجيح والسؤال والجواب.
خلاصة نظرية المقاصد عند الشاطبي:
قسَّم الشاطبي المقاصد إلى قسمين: قسم يرجع إلى مقاصد الشرع، وقسم يرجع إلى قصد المكلف في التكليف.
القسم الأول: وله أربعة أنواع:
1 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة ابتداءً.
2 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة للإفهام.
3 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة للتكليف بها.
4 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة لدخول المكلف تحت حكمها.
أما القسم الثاني، فإنه قد تحدث فيه عن اثنتي عشرة مسألة، بيَّن فيها مقاصد المكلَّف المعتبرة في التصرفات – عبادات ومعاملات من ضرورة إخلاص النوايا، ووجوب موافقة قصد المكلف ونتائج تصرفاته لأحكام التشريع – كلاًّ وجزءاً.
وفي النوع الأول – [من القسم الأول] – تحدث عن ثلاث عشرة مسألة، ابتدأ بيانها بقوله: « تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون ضروريةً، والثاني أن تكون حاجيةً، والثالث أن تكون تحسينيةً »([12]).
ثم يضيف – موضحاً – : « ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة »([13]).
لقد قسم الشاطبي مقاصد الشريعة إلى ثلاث مراتب:
1 – الضرورية:
وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث يترتب على فقدانها ضرر عظيم في الدنيا وخسران مبين في الآخرة.
2 – الحاجية:
وهي التي بمراعاتها تتم التوسعة ورفع الضيق، فإذا لم تراعَ لَحِقَ المكلفين – على الإجمال – حرج ومشقة، لكنه دون ما يحصل بفقدان الضروري. وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات.([14])
3 – التحسينية:
وتتلخص في الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب ما لا يليق. وهي تشمل مكارم الأخلاق.([15])
وحفظ هذه المقاصد يكون من جهتين:
الأولى: من جهة الوجود؛ وذلك بتحقيق ما يقيم أركانها، ويثبت قواعدها.
الثانية: من جهة العدم؛ وذلك بدرء ما يسبب اختلالها أو إفسادها، سواء كان الإفساد واقعاً أو متوقعاً.
فلحفظ الدين – من جانب الوجود – شرعت أصول العبادات. كالإيمان، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج… ولحفظه – من جانب العدم – شرع الجهاد وقتال المرتدين.
وأعلى هذه المراتب الضروري، ثم الحاجي ثم التحسيني. والمقصد الأدنى – منها – مكمل للأعلى. بشرط ألا يعود عليه بالإبطال؛ لأن المحافظة على الأصل أولى من المحافظة على التكملة.([16])
ففي مجال المعاملات: يُعدُّ البيع أصلاً ضرورياً، ونفي الغرر والجهالة مكملاً. وتحقيق هذا الشرط [نفي الغرر والجهالة] – تحقيقاً تاماً – قد يكون متعذراً بحيث يعود اعتباره – على أصل البيع – بالإبطال؛ لذا قد يتجاوز عن تحقيقه بصفة مطلقة.
وبما أن المصالح الضرورية – في الشريعة – أصل للحاجية، كان في الحفاظ على الحاجي والتحسيني خدمةٌ للضروري([17]). يقول الشاطبي: « فالمجترئ على الأخف – بالإخلال به – مُعَرَّضٌ للتجرء على الضروريات، فإذاً قد يكون في إبطال الكمالات – بإطلاق – إبطال الضروريات بوجه ما »([18]).
ويسلك [الشاطبي] – في استدلاله على إثبات المقاصد – نهجاً متميِّزاً، فهو يعتمد أسلوب الاستقراء العام للشريعة ليرتقي بها من الظنية إلى القطعية. ذلك أننا إذا نظرنا إليها أفراداً ألفيناها أدلةً ظنيةً، وهذا ما لا يُستند إليه في إثبات الشريعة. ولكن الدليل على المسألة – كما يقول الشاطبي – : « ثابت على وجه آخر هو روح المسألة… ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حدِّ الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم – من مجموعها – أمر واحدٌ تجتمع عليه تلك الأدلة، على ما ثبت – عند العامة – جود حاتم، وشجاعة علي – رضي الله عنه – »([19]).
إن هذا المنهج – الذي اعتمده الشاطبي لإثبات قطعية الأدلة في بناء الأحكام على المقاصد – ربما يكون فيه نظر يتم توضيحه فيما بعد.
والنوع الثاني – [من القسم الأول] – تعرض لبيان خمس مسائل. خلاصة القول فيها: أن الشريعة جاءت بلغة عربية، وأنها بنيت على معهود الأميين من العرب.([20])
فلا بدَّ لفهم الشريعة ومقاصدها من هذين الأساسين؛ إذْ ما دام القرآن الكريم قد نزل بلسان العرب، لزم فهمه به دون غيره.
أما كون الشريعة أميّةً، فلبنائها على معهود الأميين من العرب الذين يتميز كلامهم بالبساطة في الاستيعاب، والعفوية والبُعد عن التكلف والتصنع؛ مما يجعل الشريعة ميسرةً لدخول الناس كافةً تحت حكمها.
وفي النوع الثالث – [من القسم الأول] – تحدث عن اثنتي عشرة مسألةً، تتلخص في قدرة المكلف على ما كُلِّف به؛ ذلك أنه ليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق. فالطلب – على الحقيقة – إنما يتعلق بدائرة الأفعال التي يمكن للمكلف اكتسابها.([21])
أما إِنْ كان التكليف مما يشتبه في أمره – أي لا يُعلم هل الفعل المطلوب مقدور للمكلف أم لا؟ – كالحب والبغض والشجاعة والجبن وعموم الصفات الباطنة مما لا قدرة للإنسان على إثباته ولا نفيه، فإِنْْ كان من أصل الخِلْقةِ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإِنْ كان لهذه الصفات بواعث تدخل في كسب المكلَّف طُولب بالبواعث، كما هو شأن الهدية الباعثة على المحبة في قوله صلى الله عليه وسلم : « تهادوا تحابوا »([22]).
أما التكليف بما هو مقدور لكن فيه مشقة، فيبن الشاطبي أن الشارع لم يقصد إلى المشقة في الأصل، وإلاَّ لمـا شرع الرخص ورفع الحرج. وإنما قصد الشارع من التكليف([23]) – وإنْ شابته مشقةٌ – تحقيق مصالح عائدة للمكلف.([24])
ويخلص – [الشاطبي] – إلى قواعد مهمة. من أبرزها أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها لعظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل؛ لأن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد خالف قصد الشارع باطلٌ.([25])
ويحدد – في الأخير – ضابطاً مهماً، وهو أنه متى كانت المشقة الواقعة بالمكلف خارجةً عن معتاد المشقات في الأعمال العادية، مما يؤدي إلى فساد ديني أو دنيوي، فإن مقصود الشارع رفعها على الجملة.
ويختم [الشاطبي] هذا القسم ببيان الحكمة من رفع الحرج عن المكلف، وهي تتلخص في مسألتين:
الأولى: الخوف من استثقال التكاليف وبغض العبادة، مما قد يؤدي إلى هجرها.
الثانية: خوف التقصير عند الاشتغال بما هو ضروري لقيام حياة الفرد وأسرته.
وبذلك، يخلص إلى أن الشريعة قائمةٌ على أساس التوسط الذي يحفظ دوامها واستمرارها.
والنوع الرابع – [من القسم الأول] – يتعلق ببيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة والالتزام بها، ويتمثل – كما عبَّر عنه – في : « إخراج المكلَّف من داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً »([26]).
ولتقرير ذلك ساق أدلةً([27]) نقليةً وعقليةً كثيرةً وخلص إلى قواعد مهمة، أبرزها بطلان العمل المبني على الهوى. ثم قسَّم المقاصد الشرعيةَ إلى: مقاصد شرعية وأخرى تابعة. فالأصلية هي الضرورية المعتبرة في كل زمان وملة([28])، والمكلف ملزم بحفظ هذا النوع من المقاصد. إذْ لا حظَّ لـه فيه. أما التابعة، فهي التي روعي فيها حظُّ المكلف. وهي تُعدُّ خادمةً للمقاصد الأصلية ومكملةً لها.
وإلى جانب المقاصد الأصلية العينية يضيف الشاطبي المقاصد الأصلية الكفائية التي لا تستقيم الحياة إلا بها. كالقضاء والإفتاء والولايات العامة، وغير ذلك من الأمور التي شرعت لمصالح الناس عامةً.([29])
وقد قسمها إلى ما هو متعلق بالعبادات وأن الأصل فيه التعبد دون التفات إلى المعنى، وهذا القسم لا ينوب فيه أحد عن أحد، فلا يقوم به عن المكلف غيره([30])، وإلى ما هو متعلق بالعادات والمعاملات التي ليس في نفيها ولا إثباتها دليل شرعي، وهي طريق الحظوظ العاجلة. كالعقود – على اختلافها -، والتصرفات المالية – على تنوعها([31]) –؛ فالأصل – في هذا النوع – الالتفات إلى المعاني وقابلية التفريع والإنابة.
وقد توَّج الشاطبي حديثه عن المقاصد – ضمن كتاب الموافقات([32]) – بخاتمة تُعدُّ خلاصةً لما بحثه وأحد أهم ثمراته، وهي – في صيغة سؤال – عن كيفية معرفة ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصوداً ؟([33]).
وقبل بيان هذه الكيفية، يُلخِّص أبو إسحاق مواقف العلماء من المقاصد وكيفية تعرفها. وهي المواقف التالية:
الموقف الأول:
موقف القائلين بأن مقاصد الشرع لا يمكن أن تُعرف إلا من خلال تنصيص الشارع عليها صراحةً. وبهذا قال الظاهرية.
الموقف الثاني:
موقف الذين لا يعتدون بظواهر النصوص، ويعدون مقاصدها أمراً باطناً. وهؤلاء هم الباطنية الساعون إلى إبطال الشريعة.
الموقف الثالث:
موقف المغالين في استخدام القياس وتقديمه على النصوص.
الموقف الرابع:
يجمع أصحابه – في توسط – بين: مراعاة النصوص وظواهرها، وعدم إغفال المعاني والعلل. وهذا الموقف يمثل – بحق – منهج العلماء الراسخين، ويُعتبر الضابط الذي يُعرف به مقصد الشارع.
وبعد هذا التوضيح والبيان، يحدد الجهات التي يعرف منها مقصد الشارع، وهي:
1 – الأمر الابتدائي التصريحي المجرد.
2 – علل الأمر والنهي.
3 – المقاصد التابعة المؤكدة للمقاصد الأصلية.
4 – عدم الفعل مع وجود المقتضى. ([34])
المقاصد في فكر الشاطبي:
لعل مما يميِّز الشاطبي – من خلال ما تناوله في مؤلفاته – اهتمامه بالكليات، ونظرته العميقة لأسرار التشريع وفلسفته؛ فكتاب «الموافقات» وإِنْ صُنف في خانة الكتب الأصولية، فإنه يختلف عنها منهجاً وأسلوبَ دراسةٍ.
فإلى جانب اشتماله على مباحث أصولية، تناول مسائلَ فقهيةً وقضايا لغويةً، وقواعدَ تربويةً – كل ذلك في حرص شديد على سلامة الشريعة – حتى إن المتأمل فيه يكتشف ملامح مدرسة فكرية وتربوية، أساسها وقوامها الربانية التي توجه الإنسان المسلم الوجهة السليمة في تعامله مع أحكام الشريعة.
وليس بمستغرب على عالم كالشاطبي أن يبلغ هذا الشأو؛ فقد توفرت له – من الصفات الشخصية المتميزة والتكوين العلمي الراسخ – ما أهَّله لاستيعاب جهود سابقيه والقيام بإسهام مهم ظل إلى وقتنا الحاضر شاهداً على مكانته السامية بين فقهاء الأمة ومفكريها.
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن إسهامات الشاطبي العلمية – لاسيما تأصيله العلمي لنظرية المقاصد ودعوته المستميتة لمقاومة البدع – تعكس تجاوباً صادقاً، وتأثراً وتأثيراً واضحين بين العالم وعصره. فعصر أبي إسحاق كان عصر فساد سياسي وانحراف ديني وانحلال اجتماعي وخلقي؛ مما فرض عليه – وهو العالم الرباني – أن يبذل غاية وسعه في الإصلاح والتعليم ومقاومة الانحرافات والبدع، للأَوْبَةِ بالأمة إلى الكتاب والسنة بعد أن بلغ البُعد بها – عنهما – مبلغاً كبيراً. وقد لاقى في سبيل دعوته الإصلاحية كثيراً من الأذى والتشهير على يد علماء عصره الذين أثاروا عليه الخاصة والعامة. يقول في هذا الصدد – مصوراً شدة الحملة عليه -: « فقامت عليَّ القيامة، وتواترت عليَّ الملامة، وفوَّقَ إليَّ العتاب سهامه، ونُسبت إلى البدعة والضلالة، وأُنْزِلتُ منزلة أهل الغباوة والجهالة »([35]).
وعلى الرغم مما بذله من جهود مضنية، فإنه لم يفلح في إصلاح الأوضاع؛ لأن موجة الفساد كانت أقوى بكثير من محاولاته الفردية المحدودة.
وقد امتحن بمحن متتالية تركت أثراً موجعاً في نفسه حتى كاد اليأس أن يسيطر عليه؛ وهذا ما تلمسه عند قراءة قوله: « اعلم يا أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا، وذهاب الإخوان، وقلة الأعوان، وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حلَّ بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة »([36]).
وعلى الرغم من شدة المحن التي واجهته لم يتخل عن دعوته الإصلاحية، وإِنْ حملته على تغيير منهجه؛ حيث اعتمد على مبدأين أساسين. أولهما التمسك بالمبادئ التي آمن بها ودعا إليها. وثانيهما المرونة والتدرج في معالجة الأمور بدل المصادمات الحادة مع خصومه. يقول – في ذلك -: « فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئاً. فأخذت على حكم التدريج في الأمور.. »([37]).
لقد أدرك [الشاطبي] أنه لا يستطيع أن يقدم أكثر مما فعل في ظل مجتمع شابه الانحراف العقدي، وسيطر عليه الفساد السياسي والخلقي. لذا، نجده يقتصر أخيراً على محاولة ربط الأمة بمقاصد الشريعة.
[1] – البرهان. 2/518.(فقرة:742)
[2] – م.س. 1/206. (فقرة:205).
[3] – شفاء الغليل. ص 161-172؛ والمستصفى. 1/286-293.
[4] – ج2-ق2/217-218.
[5] – 4/251 وما بعدها.
[6] – 1/8. بيروت، دار الجيل. ط: 2. (1400هـ/1980م).
[7] – م.س. 1/11.
[8] – 20/48. مجموع فتاويه. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. الرياض، دار عالم الكتب. (1412هـ/1991م).
[9] – 3/14.
[10] – مقاصد الشريعة، ابن زغيبة. ص 58.
[11] – جمعها: محمد أبو الأجفان في كتاب واحد تحت عنوان: «فتاوى الإمام الشاطبي».
[12] – الموافقات. 2/7.
[13] – م.س. 2/8.
[14] – م.س. 2/9.
[15] – م.س.
[16] – م.س. 2/11.
[17] – م.س. 2/13.
[18] – م.س. 2/17.
[19] – م.س. 2/39.
[20] – م.س.2/49 وما بعدها.
[21] – م.س. 2/82.
[22] – أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. 6/169؛ والطبراني في المعجم الأوسط. 7/190؛ وابن عبد البر في التمهيد. 6/381.
[23] – التكليف – في حقيقته -: أمرٌ أو إلزامٌ – بمقتضى خطاب الشرع – بما فيه كلفة ومشقة، ولكنها ليست خارجةً عن المعتاد. معجم مصطلحات أصول الفقه، سانو. ص 144.
[24] – الموافقات. 2/91-98.
[25] – م.س. 2/98.
[26] – م.س. 2/128.
[27] – م.س. 2/129 وما بعدها.
[28] – وهي الخاصة بحفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
[29] – الموافقات. 2/137.
[30] – م.س. 2/174.
[31] – م.س. 2/177.
[32] – الجزء الثاني منه.
[33] – م.س. 2/296.
[34] – ذلك أنه إذا سكت الشرع عن حكم مع وجود معنى يقتضي ذلك الحكم، يكون سكوته مسلكاً يعلم منه مقصد الشارع في عدم ذلك الحكم المظنون. مثال ذلك سجود الشكر على مذهب مالك، فقد سكت الشرع عن وجوبه مع توفر دواعيه؛ لذا عُدَّ فاعله مبتدعاً في الدين.
[35] – الاعتصام. ت: محمد رشيد رضا. بيروت، دار المعرفة. ط: 1. (1982م). 1/27.
[36] – م.س. 1/86.
[37] – م.س. 1/27.
 الحركة الحركة الإسلامية المغربية
الحركة الحركة الإسلامية المغربية